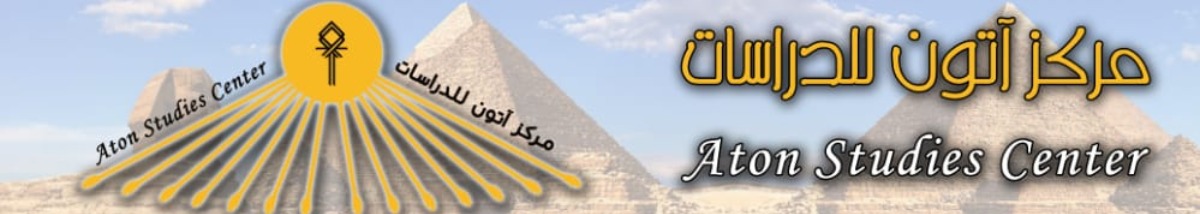مخاضات السرديات الكردية في أزمنة الانتقال السياسي .. من التاريخ للواقع
تحليل: د. أحمد محمد إنبيوه

في أزمنة الانتقال السياسي يعاد تشكيل السرديات السياسية وفق أبجديات القوة والمصالح والتآلف القومي. ففي ظل مناخات الانقسام التي تسود تلك الفترات، تبرز الحاجة لثابت، لكن هل الثابت ذاته يظل صلبا أما يحاول التأقلم مع المتغيرات الجديدة. بمعني مباشر، هل السردية الكردية بحاجة إلى إعادة إنتاج في فضاء ما بعد الأسد. ولهذا، ربما يبدو من المناسب العودة إلى السردية اللاضمة للجسد الكردي تفكيكا وقراءة بين الفينة والأخرى، خصوصا في المخاضات اللاهثة التي يحياها هذا الجسد منذ فرار الأسد وتحلل كل ميكانيزمات دولته الفكرية لا المادية فقط. ففي أوقات التحلل السياسي للثوابت، تغدو هذه الثوابت بمثابة مصباح هادي في سياق هذا الضباب العام الحاصل على إثر عواصف ما بعد الأسد. ويغدو التساؤل عن جدوى إعادة إنتاجها لتغدو متناسبة مع فضاءات ما بعد الأسد منطقيا تماما. إذ، لسنوات ظلت السردية الكردية سردية مقاومة، وتحولت قليلا بعد الانتفاضات الشعبية في ٢٠١١، لتتحول من منطق التنظير السياسي المقاوم، لبراح التأسيس الجيوسياسي. وقد أعطى النجاح النسبي لتجربة شمال شرق سوريا الفرصة لتدعيم الانتقال من براح التنظير لأنفاس التطبيق. لنقترب أولا من السردية الكردية في قوامها الصلب وتكونها التدريجي من مخاضات صعبة على آفاق بدايات القرن العشرين.
فحتى بالنسبة لأكثر المراقبين خبرةً، شهدت السياسة في الشرق الأوسط تغيرات غير مسبوقة في فترة زمنية قصيرة جدًا. كما أشار ريتشارد هاس، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية ورئيس مجلس العلاقات الخارجية، في مقال نشرته فورين أفيرز حول التغيرات السريعة في المنطقة: “النظام القديم في الشرق الأوسط يختفي. لا تزال هذه المرحلة الانتقالية في بداياتها، وما سيأتي بعدها (ومتى) غير مؤكد… من المحتمل أن يتم إعادة رسم بعض الحدود، وقد تظهر دول جديدة.” رغم أن هذه التغيرات تبدو سريعة اليوم، إلا أنها بدأت ببطء، وبشكل شبه غير محسوس، مع تفاعل قوى اجتماعية مختلفة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع تبلور النظام السياسي لدول الشرق الأوسط. فقد تداخلت التيارات الاجتماعية المتنوعة—سواء الدينية أو الطائفية أو القومية، أو المستندة إلى البُنى الاجتماعية التقليدية كالقبائل، أو تلك التي نشأت تحت تأثير الحداثة—مع قوى الدولة، مما أدى إلى تكوين واقع سياسي معقد وخطير في كثير من الأحيان، في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. تمثلت المشكلة الجوهرية في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية في وجود نظام دولي مفروض ساهم في صعود أنظمة استبدادية، وأنتج ديناميكيات قومية مهيمنة: القومية العربية في الدول العربية، والقومية التركية في تركيا، والقومية الفارسية في إيران، والصهيونية في إسرائيل. ومن هذه الإشكالية البنيوية نشأت العديد من القضايا التي بدت غير قابلة للحل. وكانت أبرزها، في الأوساط السياسية والأكاديمية، الصراع العربي–الإسرائيلي وقضية فلسطين، وهي مسألة شهدت في القرن الحادي والعشرين تحولًا لافتًا، حيث تراجعت أهميتها على أجندة صناع القرار، حتى وإن بقيت تحتل موقعًا محوريًا في أذهان الباحثين والمراقبين)[1](.
وسط هذه التحولات، أين كان الكرد؟ من الناحية الدولتية، لم يكن لهم وجود، فلم تكن هناك دولة كردستان مستقلة، وظل الكرد مهمشين ومقموعين في كل الدول التي عاشوا فيها. خلال هذه الفترة، لم يكن الكثيرون يتوقعون أن تصبح القضية الكردية ذات أهمية تُذكر في السياسة والعلاقات الدولية للشرق الأوسط، فضلاً عن أن قلة قليلة كانت تتخيل أن الأنظمة العسكرية في العالم العربي أو الدولة العسكرية في تركيا ستخضع لتغييرات جوهرية. لكن هذه التغيرات غير المتوقعة حدثت بالفعل.. وسط هذه التغيرات المفاجئة والعميقة، أصبح الكرد، الذين كانوا مهمشين لسنوات، لاعبين جيوسياسيين رئيسيين، إذ توافقت مصالحهم مع القوى الغربية. ونتيجة لهذه التغيرات، أصبح من الضروري إعادة النظر في “المسألة الكردية“، التي كانت في السابق مجرد أسئلة نظرية من قبيل: “هل يمكن للكرد أن يكونوا مستقلين؟”، لكنها تحولت اليوم إلى احتمالات واقعية إن لم تكن مرجحة، مما أثار نقاشًا أوسع من أي وقت مضى حول مستقبلهم. لطالما كانت معاناة الكرد جزءًا من تداعيات انهيار الإمبراطورية العثمانية، حيث انتقلوا من الحكم الاستعماري بعد الحرب العالمية الأولى إلى نظم وطنية استبدادية قوضت تطلعاتهم القومية. ومع سقوط نظام صدام حسين عام 2003، ثم انطلاق موجات الربيع العربي، برزت بوادر تغيير ديمقراطي في الشرق الأوسط، ما منح الكرد فرصًا غير مسبوقة. يشير اعتراف مسؤولين دوليين بأن اتفاقية سايكس-بيكو (1916) لم تعد ذات جدوى بعد قرن من توقيعها، إلى التغيرات الجذرية في المشهد الإقليمي.. اليوم، لم يعد الكرد مجرد لاعبين هامشيين في المنطقة، بل أصبحوا في قلب الأحداث. ومع ذلك، فإن مكتسباتهم، خاصة في العراق وسوريا، ليست مضمونة على المدى الطويل. فالسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه الآن هو: “ماذا بعد؟” وسط هذه التحولات العميقة في الشرق الأوسط. لا يمكن التنبؤ بمستقبل الكرد بسهولة، لكن فهم العوامل الحالية يساعد في استشراف السيناريوهات المحتملة لمستقبلهم السياسي والاجتماعي في السنوات المقبلة ([2]). وماذا يتنظر السردية الكردية إجمالًا في الفترة المقبلة، هل ستتحول إلى أبنية سياسية تشاركية تحتمل وجود الكرد كفاعل في الفضاء الجيوسياسي للمنطقة.
كردستان على منحى رومانسي موجودة في عقول وقلوب الكرد و”على مستويات عديدة في خطاب سكانها، ومؤيديها، وأولئك الذين ينكرون وجودها ذاته.” وقد تم تتبع تاريخ التعبئة السياسية في الدول المختلفة التي تضم الكرد، وكذلك انتشار الرموز الوطنية([3]). لكن هذا الوجود هل يعني صلابة وتماسك السردية الكردية وقدرتها على الإقناع العام بتناسقها وتعاضدها الداخلي أمام الحشد الجيوسياسي المحيط بفضاءات الكرد الأربع.. إن تناول السردية الكردية من حيث كونها سردية تاريخية لا هوياتية أيدولوجية وفقط، يتقاطع مع منطقية التأريخ لفكرة المقاومة لدى الكرد ولدى غيرهم من الجماعات “المهمشة”. فخلال العشرين عامًا الماضية، يمكن بلا شك ملاحظة تزايد عدد المنشورات التي تركز على الشعوب والمجموعات “المنسية” في الشرق الأوسط، مثل الكرد، والعلويين في تركيا، والشيعة في العراق، والأقباط في مصر، إلى جانب مذكرات كتبها ناشطون معارضون، سواء كانوا يساريين أو إسلاميين. ومع ذلك، فإن هذه الأعمال لا تسعى إلى تقديم أساس لمقاربة جديدة للتاريخ، بل تهدف إلى الطعن في الرواية الوطنية السائدة. وفي هذا السياق، يبدو من الآمن التنبؤ بأن كتابة التاريخ الوطني ستظل سائدة لفترة طويلة قادمة. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن الكرد، كشعب، لهم الحق أيضًا في كتابة تاريخهم الوطني، خاصة وأن الروايات الوطنية الإيرانية والتركية والعربية لا تزال تتجاهل الواقع الكردي باعتباره مجرد “أمة متخيلة” ([4]).
بادئ ذي بدء، يجب التمييز بين الكتابة الأكاديمية للتاريخ وبين الكتابات التي قام بها النخب السياسية والمثقفون الكرد الذين سعوا إلى “تجذير” الأمة من خلال بناء تأريخ قومي. فعلى مدار معظم القرن العشرين، كان دعاة الخطاب التأريخي الكردي في العراق (حتى ظهور جيل من الباحثين الأكاديميين الكرد في الستينيات) وسوريا وتركيا، فاعلين متعددين يتنقلون بين المجالات السياسية والثقافية. ومن هذا المنظور، فإن التأريخ الكردي، بل والتأريخ بشكل عام، هو “جزء من بناء نطاق واسع من المعرفة والمعاني الثقافية والفكرية”، والأهم من ذلك، أنه “لا يكتسب معناه إلا عندما يكون جزءًا من عملية سياسية.” . .. وبالتالي، لم يكن من المفاجئ أن يكون رواد كتابة التاريخ الكردي في أوائل القرن العشرين من أبناء النخبة الكردية الذين تلقوا تعليمهم في الدول الغربية أو في المدارس العثمانية الغربية الطابع. وكما هو الحال مع نظرائهم العرب والأتراك، اختار منتجو التأريخ الكردي، الذين جاؤوا من مناطق مختلفة من كردستان العثمانية، الصحف والدوريات كوسيلة رئيسية لكتابة التاريخ الوطني الكردي. أدت نشأة الدول الحديثة في الشرق الأوسط إلى تقسيم الكرد جغرافيًا وإلى بروز روايات وطنية متميزة لم يكن للكرد فيها مكان. ففي تركيا، حيث تم إنكار وجودهم وتم إغلاق الجمعيات الكردية فور تأسيس الجمهورية، لم يكن المثقفون الكرد قادرين على إنتاج سردية مضادة. وبدلًا من ذلك، لجأ بعض المثقفين الكرد إلى سوريا ولبنان، حيث أسسوا رابطة “خويبون”، التي وضعت الأساس لمفهوم القومية الكردية الحديثة في تركيا وسوريا باللغة الكردية الكرمانجية ([5]).
تخيّل الأمة: ما بعد الرأسمالية الطباعية
منذ منتصف التسعينيات، بدأ تخيّل الأمة الكردية على نحو متزايد عبر الوسائط الجديدة مثل القنوات الفضائية والإنترنت. إذ أصبح الكرد، سواء في أوطانهم الأصلية أو في المهجر، قادرين على متابعة نفس النشرات الإخبارية والبرامج الوثائقية والكوميدية وبرامج المسابقات، وتدل التعليقات الإلكترونية واتصالات المشاهدين بالبرامج الهاتفية على أنهم بالفعل يفعلون ذلك. وعلى القنوات الفضائية الكردية، يتم تعويض غياب «المجال اللغوي الموحد» ببساطة من خلال البث متعدد اللغات. وتشير الأدلة إلى أن الجمهور يتعلم فهم مواد بلهجات كردية لم يكن معتادًا عليها سابقًا، كما بات لديه معرفة أكثر شمولًا بالأحداث التاريخية في مختلف مناطق كردستان، وبالرموز الوطنية مثل العلم، وبخريطة الوطن. وفيما يخص الحشد السياسي، لعبت القنوات الفضائية دورًا رئيسيًا في تنظيم المظاهرات في جميع أنحاء أوروبا بعد ترحيل عبد الله أوجلان إلى تركيا عام 1999. وعلى النقيض من ذلك، يشير شيهولسلامي إلى ضعف التعبئة الكردية عقب قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية عام 1988، مرجحًا أن امتلاك الكرد لوسائل الإعلام الفضائية هو ما ضمن ثقة الجمهور.
ومع ذلك، فقد ضحّى كثيرون بحياتهم في سبيل القضية الكردية قبل أن يتلقوا هذا التعليم الأيديولوجي المفصل – فهل هذا يعني أنهم لم يتخيلوا أمة كردية؟ لقد اعتمدت الانتفاضات الكردية المبكرة – مثل انتفاضة الشيخ سعيد (1925)، وثورة سمكو (1919-1922)، وانتفاضة الشيخ محمود البرزاني (العشرينيات)، وتمرد درسيم (1937-1938) – على شبكات الولاء العشائري أو الديني القائمة؛ في حين أن انتفاضة أرارات (1930) فشلت إلى حد كبير بسبب عدم قدرتها على استغلال هذه الروابط. ومع ذلك، كان لدى القوميين الكرد إحساس بالهوية القومية الكردية منذ أوائل القرن العشرين على الأقل. وبحلول الستينيات، تمكن الملا مصطفى بارزاني، الذي كان يتمتع بهالة الجمهورية في مهاباد (1946) ومنفاه اللاحق في الاتحاد السوفيتي (1946-1958)، من تجنيد مقاتلين وأنصار سياسيين من خارج شبكات الولاء لعشيرته، وامتد دعم حزبه الديمقراطي الكردستاني إلى ما هو أبعد من العراق. وفي الستينيات، قبل أن يتم “إثنية” الحركات الكردية، تمكن ناشطون شباب في تركيا من حشد أعداد كبيرة من المؤيدين المطالبين بحقوقهم كأعضاء في قومية مستقلة، وذلك وفقًا للأيديولوجية الاشتراكية. أما الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي تأسس عام 1975، فقد استند إلى شبكات أوسع من التعاطف الاشتراكي. وبحلول الثمانينيات والتسعينيات، كان العديد من الكرد من خارج تركيا مدفوعين للانضمام إلى قوات حرب العصابات التابعة لحزب العمال الكردستاني. كذلك، لوحظت التعبئة الإنسانية الكردية – حيث حاولت المجتمعات المحلية تقديم مساعدات مادية للكرد في دول أخرى دون أن يكونوا بالضرورة من أقاربهم – لأول مرة من قبل المجتمع الدولي بعد حرب الخليج في تمهيدٍ لعملية «توفير الراحة»، ولكنها كانت قد أصبحت أمرًا شائعًا خلال الحرب الإيرانية العراقية. كل هذه الأمثلة، سواء كانت سياسية أو إنسانية، تفترض وجود تصور متطور نسبيًا لهوية كردية مشتركة باعتبارها «مجتمع معاناة»، ومن المؤكد أن أندرسون كان محقًا في تأكيده على دور الرابطة العاطفية في تخيّل المجتمع.
ولكن هل تختلف أفكار «الكردية المشتركة» و«المعاناة المشتركة» عن مفهوم «تخيّل الأمة»؟ هل تبقى الأمة غير متخيلة عندما يكون لدى أعضائها فهم محدود للتاريخ أو الشؤون الجارية؟ هل يجب أن يكون المعيار الوحيد للتخيّل الكامل للأمة هو الإلمام بعناصر أساسية محددة من قبل الحركة القومية، أشبه ببرنامج تعليمي عقائدي؟ بالطبع لا، وقد أظهرت الدراسات المتعمقة التي أجراها بوزارسلان، وتيجل جورجاس، وواتس مدى تعقيد تطور القومية الكردية، ومدى استحالة وضع مخطط شامل يناسب جميع المناطق. وفي بعض الأحيان، يبدو أن التساؤل حول «متى بدأت القومية الكردية؟» قد وصل إلى طريق مسدود، نتيجة الخلافات حول متى تصبح «الكردية» أو «القومية الأولية» أو حتى «القومية الإقطاعية» قوميةً بالمعنى الحديث. وتعود هنا مجددًا «الرؤى الغربية المتأصلة» التي انتقدها ووجان، مما يدفعنا للتساؤل: كم عدد المعايير التي يجب أن يستوفيها الكرد حتى يتم الاعتراف بهم كأمة؟ إن شيهولسلامي يرى بوضوح الحاجة إلى توسيع نطاق التفكير: “ليست كل القوميات سياسية؛ فبعضها ثقافي، وبعضها يجمع بين الاثنين… ولأن القوميات هي التي تخلق الأمم، يمكن القول إن بعض هذه الأمم كانت سياسية منذ البداية (أي دولة-أمة)، بينما بدأ البعض الآخر ككيان ثقافي ثم تحول إلى كيان سياسي وثقافي معًا (أمة-دولة)”. وكما يرى شيهولسلامي، إن المفهوم الأكثر ملاءمة هو المجتمع «الضبابي» كما طرحه كافيراج وناقشه تشاتيرجي: “مجتمع لا يدّعي تمثيل أو استنفاد جميع طبقات الهوية لدى أعضائه… المجتمع، رغم كونه محددًا بدقة لأغراض التفاعل الاجتماعي، لا يتطلب من أفراده التساؤل عن عددهم في العالم”.
إن التحدي الذي يواجه المؤرخون في كتابة تاريخ الأقليات، أن معظم هذه التواريخ تتم كتابتها من وجهة نظر الأغلبية، ويستخدمون في كتابتها قوالب أسلوبية مؤسسة على الباترون القومي. بينما يسعى المؤرخون القوميون المضادون إلى كتابة تاريخ بديل، إلا أنهم لا يستطيعون التخلص تمامًا من تأثير القومية في كتاباتهم. ومع ذلك، يتم استخدام أمثلة من كتابة التاريخ القومي والقومي المضاد، بهدف تقديم فهم واسع النطاق لمسألة الحقوق اللغوية الكردية في تركيا. ويمكن اعتبار هذا جزءًا من تحليل تاريخي نقدي، يحاول إظهار كيف يتم بناء الأقلية الكردية اجتماعيًا وإنتاجها مادياً. يتضمن هذا التحليل مناقشة نقدية موجزة حول كتابة التاريخ القومي بشكل عام والتاريخ الكردي القومي على وجه الخصوص ([6]). يرى المؤرخون عمومًا القومية على أنها عقيدة أو مبدأ أو حجة، والتي غالبًا ما تُعتبر فكرة ثابتة، وهي قوة دافعة تظل ثابتة تحت العديد من أقنعتها. القومية أيضًا “تاريخية” بعمق في شخصيتها: ترى العالم كمنتج للتفاعل بين مختلف المجتمعات، ولكل منها طابع وتاريخ فريد، وكلها نتيجة أصول وتطورات محددة. يتم تأصيل القومية التاريخية من قبل المؤلفين الذين يكتبون تاريخًا وطنيًا يتألف من سرد الملاحم والحروب والقدم الوطني والبؤس والقدر والمنافسين والمضطهدين. يسرد أوزكيريملي “الموضوعات المتكررة في كل سرد قومي” على النحو التالي: موضوع العصور القديمة، وموضوع العصر الذهبي، وموضوع تفوق الثقافة الوطنية، وموضوع فترات الانحسار وموضوع الأبطال الوطنيين. يحدث هذا السرد داخل حدود الإقليم التاريخي، الذي يربط التاريخ الوطني بالجغرافيا الوطنية. لذلك، يخلق السرد القومي انعكاسًا للاستمرارية يسهل تخيل الأنساب والانتماءات والأصول التاريخية والجغرافية. علاوة على ذلك، فإن أسلوب السرد في كتابة التاريخ، الذي يقدم الترتيب الزمني للأحداث في نوع من السببية، له طابع رومانسي يصل بسهولة إلى عواطف الناس. لذلك، لا يمكن أن يكون تاريخ الكتابة القومي محصنًا من الشروحات شبه التاريخية والالتزامات والتناقضات. لتحقيق هذه الغاية، فإن كتابة التاريخ الكردي، التي تتكون في الغالب من مذكرات ودفاعات القادة السياسيين، ليست استثناء. بعض المؤرخين الكرد سعو لوضع النهج القائم على الأمة في مركز تحليلاتهم، والذي يضع الكرد أيضًا في مركز التاريخ العالمي. وتمنع الشعبوية والرومانسية المؤرخين الكرد من التمييز بين التاريخ والأسطورة، مما يجعل كتابة التاريخ الكردي متناقضة أحيانا وانتقائية وربما متحيزة.
سردية المقاومة.. ما بعد الفضاء العثماني
في نهايات زمن النفوذ العثماني على فضاء جغرافي هائل، ولجت إرهاصات ما بعد السقوط لتحتل كامل الفضاء المجزئ بفعل تفاهمات ما بعد الحرب العالمية الأولى. الإحساس بالغبن والسرقة كان المسيطر على الذهنية الكردية مباشرة ما بعد اتفاقات لوزان وسيفر لنطالع مثلا المقال الافتتاحي في صحيفة “روجا نو” الكردية الكرمانجية الصادرة في بيروت الاثنين ١ مايو ١٩٤٤. ” الأمة التركية سئمت من سلاطينها وطردتهم من بلادهم. أما الأمم التي تجمعت حول العرش العثماني والخلافة الإسلامية فقد انفصلت. حصل كل منها على نصيبه باستثناء الكرد. ما كان ينبغي أن نحصل عليه نحن (الكرد) وفقًا لمبادئ الحكمة والشريعة وقع في أيدي الآخرين. وهذا ما نطالب به اليوم. هذه هي قضية كردستان. عندما ندافع عن حقوقنا، تقول لنا الأمم المحيطة إننا جميعًا مسلمون وإخوة، ولا فرق بيننا. قد يكون هذا الادعاء صحيحًا، ولكن ما فعلوه ليس عدلًا. فعندما يموت الأب، يحصل كل ابن على نصيبه، ولا يجوز للأخ أن يستولي على حصص الآخرين” )[7](.
على غرار شخصيات مثل مصطفى كمال أتاتورك وساطع الحصري وشكيب أرسلان، تشكّلت أفكار منظّري القومية الكردية الجدد من خلال المؤسسات العثمانية. وقد تعود أصول الصحافة الكردية إلى أواخر العهد العثماني، حيث قام مقداد بدرخان، وهو عم جلادت وكاموران بدرخان، بنشر أول صحيفة كردية بعنوان “كردستان” في القاهرة عام 1898. كما أصبحت إسطنبول العثمانية مركزاً مهماً للجمعيات والمنشورات الكردية منذ بداية الفترة الدستورية الثانية عام 1908، وشهدت هذه الجمعيات والصحف انتشاراً واسعاً في إسطنبول ومدن أخرى. وقد صورت الدوريات الكردية في أواخر العهد العثماني المجتمع الكردي ضمن إطار الدولة العثمانية. وعندما واجهت الدولة العثمانية أزمات كبرى مثل حروب البلقان والحرب العالمية الأولى، أكد النخبة الكردية العثمانية على هويتهم العثمانية والإسلامية، وهو ما انعكس في كتابات جلال وجمورن بدرخان خلال السنوات الأخيرة من عمر الدولة العثمانية. لكن بعد الهزيمة النهائية للإمبراطورية وصعود الحركة الكمالية في تركيا، أصبح هذان الأخوان قوميين كرديين بامتياز، كما يتضح في المنشورات الدعائية لجمعية “خويبون”، التي نُشرت بلغات مختلفة أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات. وفي حين أن الدوريات الكردية في الثلاثينيات والأربعينيات في بلاد الشام واصلت تطوير الأفكار التي طُرحت في الدوريات الكردية العثمانية، إلا أنها برزت في سياق جديد. ففي ظل الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، كان النخبة الكرد العثمانيون السابقون يتكيفون مع النظام الجديد بعد تفكك الدولة العثمانية. وشكّلت كتاباتهم ردّ فعل كردي على النظام التركي الجديد، كما مثلت مرحلة جديدة في الحركة القومية الكردية، وسيلة لكسب تعاطف الغرب مع القضية الكردية. على سبيل المثال، في عام 1933، وجه جلال بدرخان رسالة مفتوحة إلى مصطفى كمال أتاتورك شرح فيها المطالب الكردية باللغة التركية، ثم نشر لاحقاً كتيباً بالفرنسية عام 1934 لعرض القضية الكردية أمام الجمهور الأجنبي ([8]).
يمكن القول إن أعضاء الأسرة العثمانية البعيدين، وهم اليونانيون، البلغار، الصرب، والألبان، قد غادروا الإمبراطورية بالفعل وحصلوا على نصيبهم بحلول بداية الحرب العظمى. ومع نهاية الحرب، تزايد التفكك حيث فقدت الإمبراطورية أراضيها العربية. أما الكرد، فقد بقوا أوفياء للسلطان العثماني والخليفة، وقاتلوا جنبًا إلى جنب مع الأتراك للدفاع عن الأراضي العثمانية المتبقية خلال حرب الاستقلال التركية (1919-1923). لكن الجمهورية التركية الكمالية، التي أسسها مصطفى كمال (أتاتورك) عام 1923، دمرت الروابط التي كانت تربط الكرد والأتراك لقرون، وهي السلطنة العثمانية والخلافة. علاوة على ذلك، فإن الطابع القومي التركي الحاد والعلماني الحصري للنظام الجديد، إلى جانب محاولات استيعاب الكرد قسرًا، زاد من ابتعاد الكرد في تركيا. في هذا السياق، بقي بعض الكرد في تركيا وناضلوا ضد النظام الجديد، بينما ذهب آخرون إلى المنفى، سواء طوعًا أو قسرًا، وهي عملية بدأت قبل تأسيس الجمهورية التركية عام 1923 وتسارعت مع ترسيخ النظام الكمالي وفشل ثورة الشيخ سعيد عام 1925. أصبحت سوريا ولبنان، اللتان وُضعتا تحت الانتداب الفرنسي بموجب عصبة الأمم عام 1920، ملاذًا آمنًا للمنفيين الكرد الهاربين من النظام الكمالي. وبالنظر إلى وجود أحياء كردية في دمشق والأراضي الكردية المتناثرة في شمال سوريا، لم يكن الكرد غرباء عن سوريا. غير أن وصول المنفيين الكرد ونشاطاتهم القومية جعل بلاد الشام مركزًا مهمًا للقومية الكردية وللصحافة الكردية مع بداية الثلاثينيات. كانت أنشطتهم في سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي خلال فترة ما بين الحربين العالميتين وخلال الحرب العالمية الثانية تشكل مرحلة مهمة في تطور الهوية القومية الكردية بعد انهيار الدولة العثمانية، وساهمت في تشكيل خطاب الهوية ما بعد العثماني في المنطقة ([9]).
بعد فشل ثورة الشيخ سعيد عام 1925، انتقل مركز المقاومة الكردية ضد النظام الكمالي من تركيا إلى أوروبا والولايات المتحدة وإيران ومصر، وخاصة إلى سوريا ولبنان. الحدود التركية-السورية التي حددتها الحكومة التركية وسلطات الانتداب الفرنسي أثرت على الكرد والعرب والأتراك الذين يعيشون في المنطقة. وفقًا لاتفاقية فرانكلين-بوليون (20 أكتوبر 1921)، ترك الفرنسيون قيليقيا للأتراك وأنشأوا إدارة خاصة للواء الإسكندرونة، الذي بقي تحت السيطرة السورية لكنه كان لا يزال مطلبًا كماليًا نظرًا لوجود سكان أتراك فيه. لم تكن الحدود تتناسب مع الحقائق الاجتماعية والديموغرافية للمنطقة، حيث انتهى الأمر ببعض الكرد من نفس القبيلة على جانبي الحدود تحت حكم دولتين مختلفتين. ومع ذلك، استمرت العلاقات الوثيقة بين كرد تركيا وأقاربهم في سوريا. في الواقع، جعلت الإدارة الجديدة في سوريا منها ملاذًا آمنًا للكرد الذين ثاروا ضد الدولة في الجانب التركي. فرّت بعض القبائل المتمردة في تركيا على طول الحدود إلى سوريا بعد ثورة الشيخ سعيد. كما تم نقل بعض المجموعات القبلية، مثل اتحاد الهويركان بقيادة حاجو آغا، والجلاليين، والحيادرانيين، الذين لم يدعموا التمرد أو حتى الذين وقفوا إلى جانب الكماليين، من قبل الدولة الكمالية إلى غرب الأناضول. ولكنهم انتفضوا ضد الحكومة، وفي النهاية فروا إلى سوريا مع أتباعهم. النخبة القومية الكردية، ومعظمهم اضطروا لمغادرة تركيا حتى قبل ثورة الشيخ سعيد، مثل الأخوين بدرخان، اجتمعوا في بلاد الشام لمحاولة جديدة لتحرير الأراضي الكردية من السيطرة الكمالية ([10]).
السردية الكردية المقاومة بعد ثورة أرارات
واصل المنفيون الكرد في سوريا ولبنان نضالهم من أجل استقلال الأراضي الكردية عن الحكم التركي. سمحت لهم السلطات الفرنسية بذلك، مما أدى إلى نشوء ميل قوي مؤيد للفرنسيين بين الكرد في سوريا، وهو ميل ما زال موجودًا حتى اليوم. في الواقع، أدت سياسات الدولة الكمالية الاستيعابية والعلمانية المتشددة، التي تسببت في ثورة الشيخ سعيد عام 1925 في تركيا، إلى إنهاء المشاعر الموالية لتركيا في سوريا، لا سيما في منطقة الجزيرة، حيث كانت هذه المشاعر قوية منذ الاحتلال الفرنسي لسوريا. في عام 1927، تأسست منظمة كردية وطنية جديدة تُدعى “خويبون” (بمعنى “كن نفسك”) في بيروت على يد الكرد المهاجرين والمنفيين من تركيا. أصبح جلال بدرخان أول رئيس لها، وجمعت المنظمة بين شخصيات كردية بارزة من خلفيات اجتماعية وأيديولوجية مختلفة، بما في ذلك زعماء القبائل والمثقفين. كان الهدف الأساسي هو تنظيم نضال مسلح مخطط له جيدًا ضد الدولة التركية. كما عقدت خويبون تحالفًا رسميًا مع حزب الطاشناق الأرمني في بلاد الشام للعمل معًا من أجل استقلال الأراضي الكردية والأرمنية. كانت رابطة خويبون مصممة على جعل القضية الكردية معروفة في الخارج. بالإضافة إلى ممثليها في سوريا ولبنان وتركيا والعراق، كان لخويبون فروع في القاهرة وباريس وديترويت وفيلادلفيا ولندن، كما كانت لديها علاقات دبلوماسية مع إيران وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا والاتحاد السوفيتي. نشر نشطاء ومفكرو خويبون كتيبات بعدة لغات. كانت الحكومة الكمالية في أنقرة تراقب الكرد في بلاد الشام عن كثب، وضغطت على سلطات الانتداب الفرنسي لإنهاء الأنشطة القومية الكردية في سوريا. في ثورة أرارات (1927-1931)، ثاني أكبر تمرد كردي ضد الدولة التركية، تولى الضابط العثماني السابق إحسان نوري باشا قيادة التمرد. انضم إليه زعماء قبليون محليون، بمن فيهم أولئك الذين كانوا قد وقفوا إلى جانب الحكومة التركية في ثورة الشيخ سعيد. حقق المتمردون نجاحات كبيرة في البداية، حيث تفاوضوا مع الجانب التركي بل وأسسوا حكومة كردية إقليمية صغيرة في عام 1928. وبما أن منطقة التمرد كانت تقع على الحدود الإيرانية، حصل المتمردون على دعم من الكرد في إيران وتركيا والعراق، مما جعل الثورة تستمر لفترة أطول من التمردات السابقة. كما انضم بعض الكرد من شمال شرق سوريا إلى الثورة. لكن مسار التمرد تغير عندما أقنعت الحكومة التركية إيران بإنهاء تسهيل عبور المتمردين للحدود، كما ساهمت القوة الجوية والأسلحة المتقدمة لدى القوات المسلحة التركية في قمع الثورة ([11]).
كانت سوريا واحدة من الدول الجديدة في المنطقة بعد انهيار الدولة العثمانية، واحتوت على عدد كبير من الكرد. إلى جانب سوريا، أصبحت لبنان وجهة جديدة للاجئين الكرد. انضم آلاف اللاجئين الكرد من تركيا إلى السكان الكرد الموجودين مسبقًا في سوريا ولبنان. كان هؤلاء القادمون الجدد، خاصة الكرد العثمانيون الذين كانوا مقيمين في إسطنبول سابقًا، هم الذين حفّزوا الحركة القومية بين الكرد في سوريا. تركز الكرد في شمال سوريا في مناطق متفرقة مثل جبل الكرد وعفرين وجرابلس والجزيرة، بالإضافة إلى المدن السورية الكبرى مثل دمشق وحلب وحماة. اعتمدت سياسة الانتداب الفرنسي على دعم الأقليات الدينية والعرقية لموازنة المعارضة التي قادها القوميون العرب السنة للحكم الفرنسي، مما جعل السياسة الفرنسية تختلف عن السياسة البريطانية، التي فضّلت التعاون مع الزعماء العرب السنة بدلاً من التحالف مع الأقليات. بسبب التوزيع المتفرق للكرد في سوريا، اختلفت حركتهم عن تلك الخاصة بالأقليات المترابطة جغرافيًا، مثل الدروز والعلويين. ومع ذلك، كونهم أكبر أقلية مسلمة غير عربية في سوريا، لعب الكرد دورًا مهمًا في السياسة السورية ([12]).
أدت الحرب العالمية الثانية إلى ظهور فرص جديدة للكرد في إيران، حيث كانت ثورة سمكو قد قُمعت في صيف عام 1922. اضطر سمكو إلى المنفى في تركيا والعراق، ثم عاد إلى إيران عام 1925، لكن الحكومة الإيرانية اغتالته عام 1928. على غرار نظيره في تركيا، كان رضا خان عازمًا على إخضاع جميع الكيانات القبلية لسلطة الحكومة المركزية، بما في ذلك الكرد والتركمان واللور. اعتمد رضا خان سياسة اللعب على التناقضات القبلية، فقام بإنشاء قوات كردية غير نظامية لاستعادة النظام في المنطقة الكردية، ثم قام بنزع سلاح القبائل واستيطانهم، وأجبر الشباب الكرد على التجنيد في الجيش الوطني، كما حظر الاستخدام العلني للغة الكردية. في أغسطس 1941، اجتاحت القوات البريطانية والسوفيتية غرب إيران بسبب الاشتباه في وجود مخططات نازية هناك. وبسبب موقفه الموالي لدول المحور، أُجبر رضا شاه على التنازل عن العرش. عززت هذه التطورات، إلى جانب الوجود العسكري للحلفاء في غرب إيران، طموحات القادة الكرد في تحقيق ما لم يتمكنوا من نيله في ظل حكمه السلطوي. لم يكن زعماء القبائل والشيوخ وحدهم من يسعون للحصول على حقوق سياسية للكرد واستقلالٍ إن أمكن، بل كانت هناك أيضًا طبقة متوسطة كردية متعلمة، متأثرة بفكرة القومية والإيديولوجيا السوفيتية، وقد أسست هذه الطبقة “لجنة إحياء كردستان” (كومالا جيانهوي كردستان). وعلى الرغم من انتقاداتهم الحادة في منشوراتهم للطبقات التقليدية مثل الأغوات والمشايخ، فقد تعاونوا لاحقًا مع هذه القيادات التقليدية التي جذبها المد القومي للجنة ([13]).
في أبريل 1945، أصبح قاضي محمد (1893-1947) رئيسًا للكومالا. منذ عام 1944، شجعت القوات السوفيتية أذربيجان والأراضي الكردية الشمالية في إيران على التحرك نحو الاستقلال الرسمي. وبدعم من السوفييت، حوّل قاضي محمد والنخب الكردية “الكومالا” إلى “الحزب الديمقراطي الكردستاني” (KDPI) عام 1945. كما انضم إليهم ملا مصطفى بارزاني وشيخ أحمد بارزاني مع رجالهم المسلحين الذين لجؤوا إلى إيران بعد فشل تمردهم في العراق (1943-1945). في ديسمبر 1945، أُعلنت حكومة شعب أذربيجان، وبعدها بشهر، في يناير 1946، أعلن قاضي محمد استقلال “جمهورية مهاباد الكردية”. حظيت الجمهورية بدعم من منظمة خويبون، حيث زار ممثلها، قدري جميل باشا، مهاباد والتقى قاضي محمد. لكن الجمهورية لم تستمر طويلًا، إذ سحقتها القوات الإيرانية وأعدمت قادتها، بمن فيهم قاضي محمد، رغم محاولاتهم التفاوض مع الحكومة الإيرانية. ومع انهيار جمهورية مهاباد، اختفت منظمة خويبون أيضًا.
إذن يمكن القول أن يوم 22 يناير 1946 يُعتبر يومًا مفصليًا في التاريخ الكردي، إذ شهد إعلان جمهورية كردستان رسميًا في مدينة مهاباد، الواقعة شمال غرب إيران. تأسست الجمهورية برعاية الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) الذي أُنشئ حديثًا، وكانت هذه أول تجربة للكرد في السيادة الحديثة بحكم الأمر الواقع، حيث بسطت سيطرتها على الثلث الشمالي من كردستان الشرقية (الإيرانية)، المعروفة باسم “روجلات” في اللغة الكردية. ومع أن الجمهورية لم تستمر سوى 11 شهرًا، فإن المناطق الخاضعة لها شهدت تطورات غير مسبوقة خلال هذه الفترة القصيرة. فقد تم عكس مسار سياسات التمركز السياسي القسري والتجانس الثقافي التي انتهجتها دولة بهلوي منذ أوائل العشرينيات بشكل حاد. كما تم تأسيس مدارس كردية حديثة، وأصبحت المرحلتان الابتدائية والمتوسطة إلزاميتين. وظهرت صحافة كردية محلية، وازدهرت اللغة والأدب والفنون الكردية. كذلك، شجعت الجمهورية مشاركة النساء في الحياة السياسية والمجتمعية، وازدهر النشاط الحزبي، وتعززت القومية الكردية التي شكلت الأساس السياسي لقيام الجمهورية. عكست جمهورية كردستان فكرة السيادة الوطنية الكردية، مما جعلها ظاهرة حديثة بامتياز. ومع ذلك، نشأت الجمهورية في إحدى أكثر مناطق روجلات تخلفًا، وهي منطقة موكريان، التي كانت تهيمن عليها علاقات اجتماعية ما قبل رأسمالية وأشكال ما قبل حداثية من الهوية الجماعية والولاء السياسي. كانت البنية التحتية الاقتصادية والتجارية في المنطقة بدائية، وكان معظم السكان أميين، كما كانت الطبقة البرجوازية الحضرية ضئيلة الحجم وتعتمد بشكل كبير على الحكومة المركزية. أما القوة المهيمنة في المنطقة، فقد تمثلت في زعماء القبائل والإقطاعيين، الذين امتلكوا حوالي 87% من الأراضي الصالحة للزراعة. هؤلاء الإقطاعيون كانوا بمثابة أتباع حديثين للسلطة البهلوية الاستبدادية، وحكموا طبقة كبيرة من الفلاحين المعدمين الذين عاشوا في ظروف أشبه بالعبودية ([14]).
إشكالية القومية الكردية والنظريات السائدة
يثير ظهور جمهورية كردستان في سياق اجتماعي ما قبل حداثي تساؤلًا جوهريًا: كيف نشأت جمهورية وطنية، وهي الشكل النموذجي للسيادة الحديثة، في بيئة اجتماعية تقليدية؟ تكمن الإجابة في الإطار الأوسع لأصول القومية الكردية ودينامياتها، باعتبارها القوة المحركة وراء تأسيس الجمهورية. غير أن القومية الكردية، رغم تأثيرها السياسي العميق وأهميتها العالمية، لا تزال تعاني من نقص في الدراسات النظرية. فالنصوص الأساسية في دراسات القومية غالبًا ما تتجاهل القومية الكردية كليًا، أو لا تتناولها إلا بإشارات عابرة. في المقابل، شهدت دراسات المناطق نموًا في الأدبيات التي تتناول القومية الكردية، لكنها غالبًا ما تعتمد نظريات القومية التقليدية—كالتأصيلية (primordialism) والإثنو-رمزية (ethnosymbolism) والحداثية (modernism)—بطريقة غير نقدية، مما يؤدي إلى إعادة إنتاج مشكلاتها التفسيرية. التأصيلية (Primordialism): تفترض هذه النظرية أن الأمم كيان موجود منذ القدم وأنها كيانات طبيعية ثابتة عبر الزمن. بناءً على ذلك، يرى أنصار التأصيلية أن القومية الكردية تعود إلى قرون، إن لم يكن آلاف السنين، متجسدةً في اللغة المشتركة، والأصل المشترك، والأرض، والعادات والتقاليد. إلا أن هذا الطرح يتجاهل الحقيقة التاريخية المتمثلة في أن كردستان، حتى أوائل القرن العشرين، كانت مشحونة بهويات جماعية فرعية (قبلية وعائلية) وأخرى فوق وطنية (دينية)، وكان الولاء السياسي فيها لامركزيًا كما هو الحال في الإمبراطوريتين العثمانية والقاجارية. وبالتالي، فإن النظريات التأصيلية تفترض مسبقًا وجود القومية التي يُفترض بها تفسير نشأتها، مما يجعلها غير تحليلية وغير علمية. الحداثية (Modernism): تعتبر هذه المدرسة أن القومية نتاج أيديولوجي للحداثة. وفقًا لهذه الرؤية، فإن القومية الكردية نشأت كرد فعل على سياسات التمركز في الإمبراطوريتين العثمانية والقاجارية خلال القرن التاسع عشر، ثم على تشكّل الدول القومية الحديثة في تركيا وإيران والعراق وسوريا خلال القرن العشرين. غير أن هذه الدراسات غالبًا ما تهمل نقد الافتراضات السوسيولوجية التي تقوم عليها نظريات الحداثة. فالربط بين نشوء القومية والتطور الرأسمالي أو التصنيع أو التقسيم الوظيفي للعمل، يتناقض مع الواقع التاريخي، حيث نشأت القومية في معظم الحالات قبل ظهور الرأسمالية أو التصنيع. الإثنو-رمزية (Ethnosymbolism): تقع هذه النظرية في منطقة وسطى بين التأصيلية والحداثية، حيث ترى أن القومية ليست ظاهرة قديمة بحتة، ولا مجرد نتاج للحداثة، بل هي إعادة تشكيل حديثة لكيانات إثنية قديمة. ورغم أن هذه النظرية تبدو متوازنة، إلا أنها تكرر إشكالية التأصيلية عبر افتراض وجود “الإثنية” كأساس سابق للأمة، مما يؤدي إلى تفسير دائري لا يشرح فعليًا كيف تتحول الإثنيات إلى أمم.
تكشف أوجه القصور في النظريات الثلاث عن نقطة ضعف أساسية: فشلها في تفسير الطبيعة المزدوجة للأمة، أي حداثتها من جهة، وامتدادها إلى الماضي من جهة أخرى. وقد وصف توم نايرن هذه الإشكالية بمفهوم يانوس الحداثي modern Janus، حيث تجمع الأمم بين السيادة الشعبية الحديثة وبين الهوية الجماعية العريقة. نقترح، في ضوء هذا النقد، تجاوز المقاربة “الداخلية” (internalism) التي تفترض أن العوامل الداخلية وحدها تفسر نشأة القومية، مما يؤدي إلى إهمال الأبعاد البينية والتفاعلات التاريخية بين المجتمعات المختلفة. فجميع النظريات التقليدية للقومية—التأصيلية والحداثية والإثنو-رمزية—تفشل في استيعاب الطبيعة التفاعلية للقومية ونشأتها في سياقات تاريخية متعددة المستويات.
إن تطور السياسة القومية الكردية في منطقة موكريان بروجهلات (شرق كردستان) وتأسيس جمهورية كردستان في مهاباد كانا نتيجة لوقوع موكريان في موقع جغرافي-سياسي وتنموي بالغ الهشاشة. فقد تموضع هذا الإقليم عند تقاطع التحولات التفاعلية التي خضعت لها الإمبراطوريات الروسية والعثمانية والقاجارية أثناء تحولها إلى دول حديثة. جعل هذا الواقع موكريان ساحة خصبة لديناميات التطور غير المتكافئ والمركب، حيث التقت فيها ثلاثة تيارات سياسية وأيديولوجية رئيسية: السياسات الكردية الاستقلالية في الإمبراطورية العثمانية (وفيما بعد في العراق وتركيا بعد الحرب العالمية الأولى)، التي تطورت بالتفاعل مع اليعقوبية التركية، والشيوعية الروسية، والقومية الإيرانية الفارسية المركزية. وقد أدت المقاومة ضد هذه الأخيرة إلى الدفع بالحركة القومية الكردية في إيران إلى الواجهة السياسية. وهكذا، وعلى غرار النموذج الفرنسي والمشاريع القومية التركية والإيرانية والعربية التي تأثرت به، نشأت القومية الكردية أيضًا كظاهرة مزدوجة (Janus-like). لقد ظهرت من خلال عملية أوسع من التطور غير المتكافئ والمركب، كان محورها إنتاج ظواهر هجينة تجمع بين الأشكال الحديثة وما قبل الحديثة. وكانت جمهورية كردستان عام 1946 أول تجلٍّ مؤسسي لهذا المسار ([15]).Top of Form
لم تتمكن الحركة القومية الكردية في المشرق خلال سنوات ما بين الحربين العالميتين وخلال الحرب العالمية الثانية من تحرير الأراضي الكردية أو إقامة دولة كردية مستقلة. ومع ذلك، فقد كان للنهضة الثقافية الكردية في المشرق تأثير كبير على الخطاب القومي الكردي في العقود التالية. ومن خلال كيفية رؤية القوميين الكرد من مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية لأنفسهم، ولأعدائهم، ولغتهم، ووطنهم، وتاريخهم، وعقائدهم الدينية، ودور الرجال والنساء في تشكيل الطموحات القومية الكردية، من خلال هذا كله ستكتمل الصورة وتظهر السردية أكثر. هذا بالإضافة إلى دور الصحافة الكردية في المشرق، بوصفها كانت وسيلة تعبير عن الطموحات القومية للكرد وتأثيرها على العامة.
التحول في السردية نحو التأسيس الجيوسياسي. . أو في الطريق لمنع عودة الاستبداد
ظل مفهوم الدولة دومًا، بما يحمله من دلالات تتعلق بالسيادة، والحدود، والشرعية السياسية، محورًا إشكاليًا في السردية الكردية، نظرًا لكون الكرد شعبًا موزعًا بين عدة دول لم يكن لهم فيها كيان سياسي مستقل. في السياق السوري، لعبت الدولة المركزية تاريخيًا دورًا قمعيًا تجاه الطموحات الكردية، مما جعل السردية الكردية تتشكل في إطار مقاومة الدولة القومية العربية التي سعت إلى صهرهم داخل الهوية الوطنية السورية. إلا أن التحولات التي شهدتها المنطقة، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية، ومن ثم تصاعد النزاع المسلح، فرضت تغيرات جوهرية في هذه السردية. ورحيل الأسد، سواء على المستوى الرمزي أو الفعلي، يعني زوال إحدى ركائز الدولة القومية التي طالما شكلت عائقًا أمام تطلعات الكرد. وفي ظل هذه التغيرات، تحول الخطاب الكردي من خطاب مقاومة وتهميش إلى خطاب بناء وإدارة ذاتية، خصوصًا مع ظهور تجربة الإدارة الذاتية في شمال سوريا، والتي سعت إلى تقديم نموذج مختلف عن الدولة القومية التقليدية، يقوم على الفيدرالية والتعددية الإثنية والثقافية. هذا التحول في السردية لم يكن مجرد رد فعل على الفراغ السياسي، بل جاء نتيجة تراكمات تاريخية ورؤية سياسية جديدة ترى إن الدولة، بمفهومها الكلاسيكي، لم تعد بالضرورة النموذج الأمثل لتحقيق الطموحات القومية الكردية. بدلاً من ذلك، برزت تصورات أكثر مرونة، تتراوح بين الفيدرالية والكونفدرالية، كحلول وسطية تتيح للكرد هامشًا من الاستقلالية دون الاصطدام المباشر مع القوى الإقليمية والدولية. مع ذلك، لا تزال هذه السردية في حالة تشكل مستمر، تتأثر بالمتغيرات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، خاصة مع استمرار الصراعات الداخلية والخارجية التي تحدد مستقبل الوجود الكردي السياسي في سوريا وما حولها.
وإذن، تقدم التجربة السورية مساحة لفهم التغييرات العميقة وبل والعنيفة في بنية السردية الكردية، من المقاومة إلى تركيب أبنية سياسية، تحمل كثير من سمات السيادة وأنساق الدولة. حيث نجحت الإدارة الذاتية في تطوير سردية سيادية في شمال شرق سوريا. ومع تصاعد خطر تنظيم داعش، تشكّل التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، وأصبح حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته العسكرية مكونًا رئيسيًا في قوات سوريا الديمقراطية (SDF) التي تأسست رسميًا في أكتوبر 2015. في سياق حزب الاتحاد الديمقراطي، وكما هو الحال بالنسبة لحركات أخرى غير حكومية تنشط في النزاعات الداخلية، فإن السعي إلى السيادة لا يُفهم على أنه مجرد محاكاة متأخرة لنموذج الدولة التقليدية، بل يجب اعتباره محاولة لإعادة صياغة مفهوم السيادة وممارسته بطرق جديدة. لم يقتصر تأثير حزب الاتحاد الديمقراطي خلال الحرب السورية على إضعاف النظام السياسي القائم فحسب، بل ساهم أيضًا في تشكيل وإنتاج بنية سيادية بديلة. ومع تزايد الطابع الإقليمي والدولي للحرب ضد داعش، أصبح الحزب لاعبًا رئيسيًا في تكوين كيان كردي مستقل يفرض سيادته الفعلية على إقليم محدد وسكانه. وبالتالي، فإن نشوء نموذج سيادي بحكم الأمر الواقع في شمال شرق سوريا يطرح تساؤلات تحليلية جديدة حول كيفية قيام حزب الاتحاد الديمقراطي بمحاكاة واستبدال مفهوم الدولة القومية الوستفالية في سوريا ([16]). أو بصيغة أخرى كيف تحولت السردية الكردية باتجاه بناء فضاء سياسي بديل لتجربة الدولة بالنسق الوستفالي، وبديل لأغلب الوجوه التاريخية للسردية الكردية؛ التي ظلت طويلا سردية مقاومة، لكنها تحولت في فضاءات ما بعد ٢٠١١ لتأخد وجوهًا جديدة.
عانى الشرق الأوسط الحديث، منذ نهاية الحكم العثماني عام 1918، من قرن كامل من الحروب والصراعات المتواصلة. بلغ سفك الدماء ذروته بعد حرب العراق (2003)، التي أنهت حكم صدام حسين الذي دام 30 عامًا وأطلقت حقبة جديدة من التغيرات التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من تونس ومصر وليبيا إلى قلب الكيانات السياسية الإقليمية مثل العراق وسوريا. هذه التغيرات، التي لا تزال قيد التطور، أدت إلى صعود جهات فاعلة تتمتع بحكم الأمر الواقع مثل حكومة إقليم كردستان في شمال العراق (1992)، وكذلك كيانات غير حكومية مثل روج آفا (كردستان الغربية)، التي أُعلنت منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في شمال شرق سوريا في 11 نوفمبر 2013 ([17]). حتى قبل اندلاع الانتفاضات العربية في ديسمبر 2010، كانت هناك إشارات إلى أن الكرد في سوريا بدأوا في كسر صمتهم الطويل، كما تجلى ذلك في الانتفاضة الكردية الصامتة عام 2004. كما كانت هناك توقعات بأن سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مثل مبادرة “الشراكة الشرق أوسطية” التي أطلقها جورج بوش، سيكون لها تأثير على القضية الكردية في سوريا، خاصة مع دعم واشنطن لبعض الجماعات الإصلاحية السورية ([18]).
يعد المكون السياسي الركيزة الأهم في سيادة الفاعلين المسلحين من غير الدول، حيث يشكل عنصرًا أساسيًا في النموذج الوستفالي للدولة. تقوم الدولة الوستفالية الحديثة على عدة أسس رئيسية، تشمل احتكار استخدام القوة، وصياغة الهوية الأيديولوجية، والتحكم السياسي في السكان والموارد، والاعتراف والدعم الخارجي لتعزيز الشرعية. عند دراسة الجماعات المسلحة غير الدولتية، يتضح أن التكوين الأيديولوجي، ومنطق الشرعية (سواء القسري أو الطوعي)، والاعتراف الدولي جميعها تلعب أدوارًا جوهرية في تشكيل قواعد حكم ذات طابع سيادي شبيه بالدولة. يشير البعد الأيديولوجي إلى الهوية الأساسية للجماعة، والتي غالبًا ما تُبنى على تفسيرات دينية أو عرقية لوجودها. أما الشرعية، فتعني مدى قبول السلطة من قبل السكان، بينما يمثل الدعم والاعتراف الدولي عنصرًا حاسمًا ليس فقط في تأمين بقاء الجماعات المسلحة، ولكن أيضًا في تعزيز ممارساتها السيادية على المستويين المحلي والدولي.. في المحصلة، يتضح أن الجماعات المسلحة غير الدولتية تعمل وفق منطق سيادي يشبه الدولة، لكنه يتطور في بيئة نزاعية غير مستقرة، حيث تتداخل البنية التنظيمية، والعمليات القتالية، والشرعية السياسية في صياغة نموذج جديد للسلطة والسيادة ([19]).
تأسس حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) عام 2003 كفرع من حزب العمال الكردستاني (PKK)، ومنذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، أصبح يعمل كوحدة سياسية إدارية علمانية ذات طابع ما بعد ماركسي في مدن شمال سوريا. يسعى الحزب إلى إقامة منطقة حكم ذاتي كردية في شمال سوريا مقسمة إلى ثلاثة كانتونات فدرالية: عفرين (2012-2018)، الحسكة (الجزيرة)، وعين العرب (كوباني). من الناحية التنظيمية، يمتلك الحزب جناحين عسكريين رئيسيين: وحدات حماية الشعب (YPG)، ووحدات حماية المرأة (YPJ)، التي تتألف بالكامل من مقاتلات. تعتمد هذه القوات بشكل كبير على الخبرة العسكرية الطويلة لحزب العمال الكردستاني وتحظى بدعمه العسكري. ومع ذلك، ومع تشكيل التحالف العسكري العالمي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، طورت قوات YPG تكتيكاتها القتالية وتحولت إلى جيش نظامي في حربها ضد داعش. ورغم أن تركيا أدرجت حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية عام 2014، إلا أن الحزب لم يُدرج على قوائم الإرهاب الغربية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تصوير YPG نفسها كقوة عسكرية وسياسية علمانية في المنطقة، فضلًا عن كونها الفاعل المحلي الأبرز في محاربة داعش. إلى جانب العمليات العسكرية ضد داعش، وخصوصًا بدعم وتوجيه استراتيجي من التحالف العسكري الدولي بقيادة الولايات المتحدة، سعى الحزب إلى إنشاء هيكل حكم جديد يهدف إلى دمج وظائف إدارية حديثة، وهيكلة تنظيمية موسعة، بل وحتى بعض ممارسات صنع السياسة الخارجية ([20]).
حظيت هذه الممارسات ببعض القبول على المستوى العالمي، حيث وصفها البعض بأنها “ثورة صامتة بدأت في روجافا في 19 يوليو 2012، وأدت إلى إنشاء مؤتمر وطني ديمقراطي في يناير 2014، من خلال نظام الكانتونات المستند إلى الحكم الذاتي والديمقراطية التشاركية“ . لكن هذه التجربة أثارت مخاوف الدول المجاورة، حيث ينظر إليها البعض على أنها محاولة جديدة لبناء دولة كردية. وقد لعب الانسحاب الاستراتيجي للقوات السورية من شمال البلاد دورًا حاسمًا في صعود حزب الاتحاد الديمقراطي، حيث بدأت القوات الكردية المسلحة التابعة له بالسيطرة على المناطق ذات الأغلبية الكردية وما حولها منذ عام 2012. في عام 2016، أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي، من خلال قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، تشكيل “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا“، والتي قسمت المنطقة إلى سبع مناطق إدارية، تشمل: الجزيرة، الفرات، عفرين، الرقة، الطبقة، منبج، ودير الزور. ومع فقدان عفرين، تقلصت المناطق الخاضعة لسيطرة الحزب، لكنه استمر في الهيمنة العسكرية والإدارية على معظم شمال شرق سوريا. في هذا السياق، ركّز الحزب على بناء المجتمع على المستوى الإقليمي، مرتكزًا على قومية كردية غير إقصائية، تفتح المجال أمام الطوائف والمجموعات العرقية الأخرى في سوريا، مثل العرب، التركمان، الإيزيديين، والمسيحيين المحليين ([21]).
طالما تم الترويج للحكم اللامركزي كوسيلة لاستيعاب مطالب تقرير المصير دون تهديد النظام الإقليمي الدولي. ومع ذلك، تظل مزاياه كبديل للتقسيم أو الانفصال موضع نقاش مستمر، كما أن التصميم الأمثل للمؤسسات اللامركزية يثير جدلًا مشابهًا. في هذا السياق، تركز الأدبيات غالبًا على قدرة المؤسسات اللامركزية على منع الانفصال أو الحرب الأهلية، مما يطمس الإمكانيات التحررية للامركزية. تشير بعض الدراسات إلى أن اللامركزية قد توفر إطارًا لرؤية موسعة لتقرير المصير الداخلي، لا تقتصر فقط على تعزيز الحكم الذاتي للمجموعات المهمشة منذ فترة طويلة، ولكن تشمل أيضًا إعادة هيكلة الدولة بشكل جذري، بل وإعادة تصورها. تقدم التجربة الكردية في اللامركزية مسارًا مثيرًا للاهتمام. فقد طوّر عبد الله أوجلان، زعيم حركة التحرر الوطني الكردية في تركيا، نموذجًا سياسيًا لمستقبل المنطقة التي تمتد عبر أربع دول يقطنها الكرد، أطلق عليه اسم “الكونفدرالية الديمقراطية”. يجمع هذا النموذج بين اتحاد عبر الحدود وتوزيع لا مركزي واسع للسلطة داخل الحدود القائمة، وقد حظي بدعم واسع النطاق من المجتمعات الكردية في تركيا وسوريا على حد سواء.
يتميز هذا النموذج بعدد من السمات الفريدة، أولها أنه، على عكس مبادرات تفويض السلطة الإدارية من أعلى التي تبنتها حكومتا أنقرة ودمشق، تم تصميمه وتنفيذه من قبل جهات غير حكومية تمتلك شبكات شعبية قوية. في تركيا، لعب حزب الشعوب الديمقراطي وحزب المناطق الديمقراطية دورًا بارزًا في تحفيز الانتخابات البلدية من خلال برامج سياسية تركز على تمكين المجتمعات المحلية. وفي كل بلدية فاز بها الحزب، تم انتخاب رئيسي بلدية (رجل وامرأة) بالتوازي مع إنشاء مجالس قروية وحيّية غير رسمية لكنها منتخبة ديمقراطيًا، تشارك في صنع القرار المحلي. وتم تبني هذا النموذج لاحقًا في سوريا، حيث سمح ضعف سيطرة الحكومة المركزية على المناطق الكردية بإنشاء هيكل سياسي قائم على المشاركة الشعبية.
أما السمة الثانية البارزة للمقاربة الكردية للامركزية، فهي الدمج بين مطالب تقرير المصير والإصلاحات التي تعالج بشكل صريح أوجه القصور في الحوكمة. فبينما كان حزب العمال الكردستاني يسعى في البداية إلى إقامة دولة كردية مستقلة، تحولت أهدافه لاحقًا نحو بناء نظام ديمقراطي مباشر يربط المجتمعات الكردية في سوريا وتركيا والعراق وإيران ضمن هيكل جديد من الحوكمة التشاركية، دون دولة مركزية. يلتزم هذا المشروع بمبدأ أن التحرر الحقيقي يتطلب ديمقراطية اجتماعية متعددة الأعراق، حيث تتمتع جميع المجتمعات بحقوق ثقافية وإدماج سياسي في إطار سياسي شامل ولكنه غير مركزي.
اقترب هذا النموذج من التحقق بشكل واضح في شمال سوريا، حيث أسس الكرد اتحادًا فيدراليًا يُعرف باسم “فيدرالية شمال سوريا الديمقراطية” (روجآفا). وينص ميثاق العقد الاجتماعي الذي أسس هذا الاتحاد على بناء “مجتمع خالٍ من الاستبداد والعسكرية والمركزية وتدخل السلطات الدينية في الشأن العام”. وبهذا، لا يُنظر إلى اللامركزية هنا كخطوة نحو دولة كردية مستقلة أو كتعويض عن غيابها، بل كمبدأ أساسي لنظام سياسي جديد. لكن هذه التجربة واجهت تحديات كبيرة، إذ تمت إدارتها وسط حرب أهلية شرسة، وتهديدات تنظيم الدولة الإسلامية بين 2014 و2018، والتدخلات العسكرية التركية لمنع قيام كيان كردي مستقل على حدودها الجنوبية. كما أن الحركة تواجه داخليًا مخاطر الجمود الأيديولوجي بسبب هيمنة شخصية أوجلان على رؤيتها، فضلًا عن اتهامات بإفراط الحزب الحاكم في السيطرة المركزية. ومع ذلك، فإن نجاحها في جذب شرائح من العرب وغير الكرد للانضمام إلى قوات سوريا الديمقراطية لمواجهة نظام الأسد، بالإضافة إلى قدرتها على إدارة مجتمع متنوع، يشكلان شهادة على رؤية تقرير مصير تتجاوز القومية الصرفة وتحتفي بالتعددية )[22](.
اللامركزية الفعلية (De facto Decentralization)
قد تنشأ الحوكمة اللامركزية ليس فقط عندما يتشكل كيان الدولة، ولكن أيضًا عندما تبدأ في التفكك. في فترات انهيار الدولة الجزئي أو الكامل، قد تتولى الحكومات الفرعية سلطات متزايدة دون تفويض رسمي من خلال العمليات الدستورية أو التشريعية أو الإدارية. هذا الظاهرة، التي نطلق عليها “اللامركزية الفعلية”، لم تحظَ باهتمام أكاديمي واسع، على الرغم من أن بعض القضايا التي تثيرها تمت مناقشتها في أدبيات السياسات المتعلقة بالحكم في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات. وتستحق هذه الظاهرة الدراسة كنوع مستقل من اللامركزية، ليس فقط لأنها واقع ملموس في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – مثل ليبيا واليمن وأجزاء من سوريا حاليًا (وكذلك العراق ولبنان في الماضي القريب) – ولكن أيضًا لأن التجربة تشير إلى إمكانية استدامتها. يبدو أن هذا صحيح بشكل خاص في الدول التي كان الحكم المركزي الفعّال فيها ظاهرة عابرة، كما هو الحال في الصومال واليمن. وقد يحدث ذلك أيضًا في الدول التي تؤدي فيها الانقسامات الداخلية العميقة، إلى جانب الدعم الخارجي للأطراف المتنازعة، إلى خلق حالة جمود سياسي مستدام.
تشير تجارب الدول إلى أن اللامركزية الفعلية يمكن أن تستمر لفترات طويلة، ما يجعلها بديلاً جذابًا لمحاولات إعادة المركزية المفروضة من قبل جهات سياسية استبدادية أو عدائية. ومن الملاحظات الأولية حول خصائص هذه الظاهرة ما يلي: استمرار الحوكمة رغم غياب الدولة المركزية: حتى في الفترات والمناطق التي يتوقف فيها عمل الحكومة المركزية، فإن مستوى معينًا من الحكم يستمر. ففي ليبيا وسوريا، كانت الحكومات المحلية مصادر رئيسية للأمن والخدمات العامة، وأصبحت توفر آليات لحل النزاعات. الشرعية الشعبية للحكومات المحلية: غالبًا ما يُنظر إلى الحكومات المحلية على أنها أكثر شرعية من المؤسسات المركزية. ويرجع ذلك إلى الروابط الاجتماعية القوية بين المسؤولين المحليين وسكانهم، كما هو الحال في ليبيا، أو بسبب جودة واستمرارية الخدمات المقدمة، كما هو الحال في منطقة روج آفا. تحديات توحيد السياسات والتوزيع العادل للموارد: قد تؤدي اللامركزية الفعلية إلى صعوبات في تنسيق السياسات بين المناطق وضمان توزيع عادل للموارد. على سبيل المثال، أدى الدعم الخارجي للحكومات المحلية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا إلى تعقيد جهود تنسيق السياسات. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن تسهم الأيديولوجيات الموحدة والهياكل الحزبية القوية في تحقيق قدر من الانسجام في الحوكمة اللامركزية، كما هو الحال في شمال شرق سوريا / روج آفا ([23]).
عند إعادة تشكيل الدولة بعد فترة من الانهيار الجزئي أو الكامل، قد يطالب الفاعلون المحليون بالحكم اللامركزي كشرط لإعادة الاندماج في الاتحاد. يختلف هذا السيناريو عن حالات “التماسك” (Holding Together) و”التجمع” (Coming Together) المعروفة في الأدبيات السياسية. عندما تنهار الدولة المركزية، قد تجد الحكومة الجديدة صعوبة في فرض ترتيباتها على الجهات الفاعلة المحلية، خاصة إذا كانت هذه الجهات قد أنشأت بالفعل أنظمة حكم مستقلة بحكم الواقع. مثال على ذلك هو العراق خلال عملية صياغة الدستور في 2005، حيث تمكن الكرد، بعد أكثر من عقد من الحكم الذاتي الفعلي وتفكك الدولة بعد الغزو الأمريكي، من المطالبة بقدر كبير من الاستقلالية في النظام الفيدرالي الجديد، رغم الضغوط الدولية التي منعتهم من إعلان الاستقلال الكامل. ومع ذلك، فإن إعادة تشكيل الدولة لا تعني بالضرورة تبني اللامركزية. فقد تتخذ الدول المتأثرة بالنزاعات واحدًا من ثلاثة مسارات رئيسية: إعادة المركزية الكاملة: كما حدث في سوريا بعد 2018، حيث أعادت الحكومة المركزية فرض سيطرتها على العديد من المناطق التي كانت تحت حكم الفصائل المعارضة.
تقاسم السلطة داخل الحكومة المركزية: كما حدث في لبنان بموجب اتفاق الطائف، الذي أعاد توزيع السلطة بين الطوائف المختلفة. استمرار اللامركزية الفعلية: كما هو الحال في الصومال، حيث لم يتمكن أي كيان مركزي من فرض سلطته الكاملة، ما أدى إلى بقاء الحكم اللامركزي واقعًا مستمرًا. يعتمد المسار الذي ستتبعه الدول الأخرى على عدة عوامل، مثل دور القوى الخارجية، والبنية الدستورية السابقة، وحجم الوحدات اللامركزية ومدى تماسكها. لكن من الواضح أن الجهات المحلية التي اعتادت على الحكم الذاتي الفعلي ستكون مترددة في العودة إلى كيان مركزي دون ضمانات قوية للاستقلالية، سواء من خلال قدراتها العسكرية أو من خلال دعم خارجي ([24]).
تُظهر التجربة في المنطقة أن اللامركزية ليست مجرد اتفاق يُبرم في لحظة تاريخية معينة، بل هي عملية تفاوض دائمة تتأثر بتغير ميزان القوى بين مختلف الفاعلين. أدوار متعددة في عملية التفاوض: في بعض الحالات، لا يقتصر الدفع نحو اللامركزية على الفاعلين المحليين فحسب، بل قد يكون هناك إصلاحيون في الحكومة المركزية يسعون إلى استخدامها للحد من الاستبداد، أو على العكس، قد تسعى النخب المركزية إلى توظيفها لتعزيز شرعيتها وبسط نفوذها. استمرار التفاوض بعد إقرار القوانين: حتى بعد اعتماد دساتير أو اتفاقيات سلام، تبقى عملية تنفيذ اللامركزية خاضعة للتفاوض المستمر، حيث قد تُعرقل من قبل بيروقراطيات الدولة المركزية أو القوات العسكرية. التأثير المتبادل بين الصراع السياسي وتوزيع السلطة: الصراعات على الأرض تلعب دورًا حاسمًا في تحديد نتائج التفاوض على اللامركزية. على سبيل المثال، سيكون من الصعب إقناع الكرد في سوريا بقبول إدارة لامركزية ضعيفة، كما سيكون من الصعب إقناع الجنوبيين في اليمن بالتخلي عن مطلب الفيدرالية أو الاستقلال بعد أن بات لديهم سيطرة فعلية على مناطقهم ([25]).
هل الفيدرالية هي الحل لسوريا؟
في بعض الجوانب، كان كرد السوريون من أكثر الأقليات الكردية تعرضًا للاضطهاد. رغم تعرض كرد للقمع في تركيا وإيران والعراق، إلا أن تلك الحكومات على الأقل اعترفت بمواطنتهم. هذا لا يعني تجاهل ضحايا حملة الأنفال لصدام حسين، أو الفظائع التركية، أو أحكام الإعدام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن في سوريا، اختار نظام الأسد ببساطة تجاهل كرد أو تجريدهم من جنسيتهم. فقد كانت دمشق تلغي بانتظام جوازات سفر كرد وأوراق هويتهم، مما حرمهم من التعليم، وملكية الأراضي، وحتى الزواج المعترف به من الدولة. وعندما انتفض كرد احتجاجًا – كما فعلوا في القامشلي في مارس 2004 – قوبلوا بالقمع الوحشي من قبل قوات الأمن والجيش السوري. حتى بعد أن اجتاحت احتجاجات الربيع العربي الأنظمة المتصلبة في تونس ومصر، لم يتوقع سوى قلة أن تتحول سوريا إلى صراع دموي وحرب أهلية. قدمت الحرب السورية مستوى من الوحشية لم تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ اجتياح المغول في القرن الثالث عشر. لكن ربما كان كرد هم الفئة الوحيدة في المجتمع السوري التي وجدت في هذا الدمار فرصة سانحة. فكما تمكن الحزبان الكرديان الرئيسيان في العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK)، من ملء الفراغ الذي خلفه انسحاب الحكومة المركزية العراقية بعد انتفاضة 1991، فعل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، المرتبط بحزب العمال الكردستاني (PKK)، الشيء نفسه في سوريا بعد انسحاب أو انهيار إدارة الأسد في بعض المناطق. قامت وحدات حماية الشعب (YPG) بطرد قوات النظام السوري أو فرضت عليها الحصار، وهزمت مقاتلي جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وقسم كرد السوريون مناطقهم إلى ثلاث كانتونات: الجزيرة، وعفرين، وكوباني، التي أصبحت في عام 2015 رمزًا عالميًا للمقاومة، بعد أن خاضت وحدات حماية الشعب معركة شرسة استمرت لأشهر ضد تنظيم الدولة الإسلامية، رغم تفوق الأخير في العتاد والعدد )[26](.
في 29 يناير 2014، اجتمع في بلدة عامودا، شمال شرق سوريا، طيف متنوع من السوريين، ليس فقط من كرد، بل أيضًا من العرب والمسيحيين والتركمان والقوقازيين، لإقرار “ميثاق العقد الاجتماعي”، وهو بمثابة دستور أولي يجسد رؤية عبد الله أوجلان. نصت المادة الثانية على أن الشعب هو مصدر السيادة، التي تُمارس من خلال المجالس والمؤسسات المنتخبة. وأكدت المادة السادسة على مساواة جميع الأشخاص في المنطقة ذات الحكم الذاتي أمام القانون. أما المادة التاسعة، فقد اعتمدت الكردية والعربية والسريانية كلغات وطنية، وسمحت بالتعليم بأي منها، وهو خروج عن النزعة القومية الضيقة السائدة في العديد من المناطق المجاورة. وأقرت المادة الثالثة والعشرون بحق الأفراد في هويتهم العرقية أو الدينية أو الأيديولوجية أو الثقافية أو اللغوية، فيما ضمنت المادة الرابعة والعشرون حرية الفكر والتعبير، بشرط ألا يهدد ذلك السلم المدني أو يؤدي إلى الإقصاء والهيمنة. ألغى الميثاق عقوبة الإعدام، وكفل حقوقًا متساوية للنساء، وأكد على حرية التنقل. كما أسس ثلاث سلطات منفصلة: تنفيذية وتشريعية وقضائية، وأقر آليات ديمقراطية لمراقبة قوات الأمن. إلا أن نظامه الاقتصادي كان غامضًا، حيث أقر بحق الملكية الخاصة، لكنه سمح باستثناءات قانونية قد تثير الجدل، نظرًا لانتقادات أوجلان المتكررة للرأسمالية، رغم تخليه عن الماركسية الصارمة. وعلى الرغم من أن الميثاق شجع المنافسة وفقًا لمبدأ “الحكم الذاتي الديمقراطي”، فقد سمح أيضًا بالتدخل في السوق لحماية حقوق العمال والمستهلكين، ومراعاة الاعتبارات البيئية، وتعزيز السيادة الوطنية. دعا الميثاق إلى انتخابات مباشرة لمجلس تشريعي يمتلك سلطات واسعة، مثل التحكم في الميزانية، والتصديق على المعاهدات، وإعلان الحرب أو السلام، ومنح العفو. وكان من المقرر أن يُنتخب حاكم لكل كانتون، ليصادق على القوانين ويترأس مجلسًا تنفيذيًا يشرف على الإدارات الحكومية. وقد أنشأت روجافا، المنطقة الكردية ذاتية الحكم المعلنة في سوريا، 20 وزارة، شملت وزارات تقليدية مثل الخارجية والدفاع والعدل، بالإضافة إلى وزارات تعكس التجربة الكردية الخاصة، مثل وزارة شؤون عائلات الشهداء ووزارة العمل والتوظيف ([27]).
بذلك، قامت روجافا بترسيخ نموذج قد يمثل إحدى نقاط الضعف في حكومة إقليم كردستان العراق المجاورة. فعلى الرغم من أن حكومة الإقليم نظريًا كيان واحد، فإن التنافس بين الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) أدى فعليًا إلى قيام حكومتين موازيتين لكل حزب، بوزارات وأجهزة استخبارات وبيروقراطيات منفصلة. ومن خلال السماح لكل كانتون في روجافا بإدارة وزاراته الخاصة، فإنها تخاطر بإعادة إنتاج هذا الانقسام. قد تعزز المنافسة بين الكانتونات كفاءة الخدمات، تمامًا كما أدى التنافس بين الحزبين الكرديين في العراق إلى تحسين التعليم العالي والإعلام، لكن أي تفاوت في سياسات الرفاه الاجتماعي، مثل تعويضات المحاربين القدامى، قد يخلق توترات مستقبلية. يصور ميثاق روجافا أيضًا قضاءً مستقلاً يعتمد مبدأ البراءة حتى إثبات الإدانة. كما أنشأ محكمة دستورية عليا لحل النزاعات بين السلطات الثلاث، إلا أن التجربة العملية أظهرت أن القضاء في المناطق الكردية، سواء في العراق أو سوريا، لا يزال خاضعًا لنفوذ الأحزاب، وأن الاستقلال المالي للمحاكم لا يزال أمرًا نظريًا. أنشأت روجافا أيضًا مفوضية عليا للانتخابات لتحديد مواعيد الانتخابات، وإدارة الترشيحات، وتنظيم الاقتراع بإشراف مراقبين من الأمم المتحدة – إن اختارت الأمم المتحدة إرسالهم. أما أجهزة الأمن، فتشمل “الأسايش”، وهي جهاز الاستخبارات في روجافا، الذي يتولى حفظ الأمن. كما أنشأت المنطقة “مجالس سلام” لحل النزاعات البسيطة المتعلقة بالديون أو الأراضي أو الطلاق، بينما تتولى المحاكم العامة القضايا الأكبر، استنادًا إلى مزيج من القانون الجنائي السوري وبعض القوانين الأوروبية، مثل القوانين السويسرية والألمانية. لكن في الممارسة العملية، بدا أن النظام القضائي في روجافا يعمل بأسلوب عشوائي قد يصبح أكثر إشكالية مع الوقت، بسبب تضارب الأحكام القانونية. معظم المواطنين يتعاملون مع الحكومة من خلال المجالس المحلية المنتخبة، التي تُكلف بحل المشاكل اليومية. ويعتبر مسؤولو روجافا هذه المجالس دليلاً على التزامهم بالديمقراطية الحقيقية، لكن هذه البنية الإدارية يمكن أن تصبح بسهولة أداة للسيطرة السلطوية إذا تم توجيهها من الأعلى. فمثل هذه المجالس تشبه إلى حد ما الهياكل التي وضعها الزعيم الليبي معمر القذافي في “الكتاب الأخضر” ([28]).
يعكس منطق السيادة في شمال شرق سوريا مزيجًا من التقليد والمحاكاة لنماذج الدول التقليدية، مع تطوير أشكال بديلة من الحكم الذاتي. فبينما يسعى إلى إعادة إنتاج مؤسسات الدولة الحديثة، لا يزال يواجه تحديات كبرى تتعلق بالاعتراف الدولي، والتوترات مع الدول المجاورة، والضغوط العسكرية المستمرة، مما يجعل مستقبله محكومًا بموازين القوى الإقليمية والدولية. بالإضافة إلى القدرة على الاستمرار في تأمين شرعية سياسية تضمن استمرار تجربة الحكم الذاتي ضمن إطار لا يثير عداء الدول المجاورة. ومن ثم فإن احتمالات نضج وتطور الإدارة الذاتية، تزدهر إذا توافرت إرادة دولية تدعم هذه الصيغة، لكن التحديات لا تزال كبيرة، خصوصًا في ظل الضغوط التركية، والتحولات في المشهد السوري، ومواقف القوى الكبرى المتغيرة. والخلاصة إن النجاح في ترسيخ نموذج حكم مستقر، يعتمد على قدرة الكرد على بناء تحالفات داخلية وخارجية، وتقديم نموذج إداري فعال يجذب المكونات الأخرى، فضلًا عن التعامل بواقعية مع الديناميكيات السياسية المتغيرة.
[1] Gareth Stansfield and Mohammed Shareef: introduction, in gareth stansfield and mohammed shareef: The Kurdish Question Revisited, oxford university press, 2017, pp xvii – xxxiii
[2] Ibid
[3] Allison, Christine. “From Benedict Anderson to Mustafa Kemal: Reading, Writing and Imagining the Kurdish Nation”. Joyce Blau l’éternelle Chez Les Kurdes, edited by Hamit Bozarslan and Clémence Scalbert-Yücel, Institut français d’études anatoliennes, 2018, https://doi.org/10.4000/books.ifeagd.2217.
[4] Jordi Tejel: new perspectives on writing the history of the kurds in Iraq Syria and turkey a history and state of the art assessment, in gareth stansfield and mohammed shareef: The Kurdish Question Revisited, oxford university press, 2017, p 6
[5] Ibid
[6] Nesrin Ucarlar: Between Majority Power and Minority Resistance Kurdish Linguistic Rights in Turkey, Sweden, Lund University, 2009, pp 98 – 99
[7] Ahmet Serdar Aktürk: Imagining Kurdish Identity in Mandatory Syria: Finding a Nation in Exile, University of Arkansas ProQuest Dissertations & Theses, 2013. p 2
[8] Ibid
[9] Ibid: p 8 – 9
[10] Ibid: p 64
[11] Ibid: p 65 – 68
[12] Ibid: p 69
[13] Ibid: p 78 – 79
[14] Kamran Matin and Jahangir Mahmoudi: The Kurdish Janus: The intersocietal construction of nations, nations and nationalism, volume 29, issue 2, April 2023, p 718 – 733, https://0810e0wjf-1104-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1111/nana.12932
[15] Ibid
[16] Murat Yeşiltaş and Tuncay Kardaş: Mimicry and substitution in the logic of sovereignty: the case of PYD, Int Polit 60, 154–173 (2023).https://doi.org/10.1057/s41311-021-00293-5
[17] Marianna Charountaki: Kurdish policies in Syria under the Arab Uprisings: a revisiting of IR in the new Middle Eastern order, Source: Third World Quarterly, 2015, Vol. 36, No. 2 (2015), p. 337
[18] Marianna Charountaki: Kurdish policies in Syria under the Arab Uprisings: a revisiting of IR in the new Middle Eastern order, Source: Third World Quarterly, 2015, Vol. 36, No. 2 (2015), p. 338
[19] Murat Yeşiltaş and Tuncay Kardaş: op cit
[20] Ibid
[21] Ibid
[22] Huseyin Tunc: Kurdayetî and Kurdish Nationalism: The Need for Distinction The Journal of Critical Global South Studies. 2018. Vol. 2(1):43-64. DOI: 10.13169/zanjglobsoutstud.2.1.0043
[23] Ibid
[24] Ibid
[25] Ibid
[26] Michael Rubin: What Do the Kurds Want?, American Enterprise Institute (2016), pp 44 – 47 , https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep03254.6.pdf?refreqid=fastly-default%3A74c3fce6159942efebd855c31675d7e7&ab_segments=&initiator=&acceptTC=1
[27] Ibid
[28] Ibid